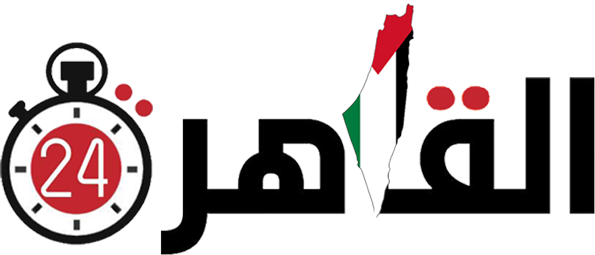خالد طلعت يكتب: نماذج مَرضية في كل مكان

ليس من المستغرب أن تشاهد شخصًا في المواصلات العامة بالدول الغربية المتقدمة يمارس فعلا منافيًا للآداب بلا أي حياء وسط جموع المسافرين، وقد شاهدت هذا بنفسي أكثر من مرة، كانت آخرها في الصبواي بمدينة نيويورك، والذي يحظى بسمعة خاصة في هذا المجال، يومها دخل أحد “حطام البشر” إلى العربة، وكان في حالة مزرية ورائحة لا تطاق ثم جلس في هدوء على الأريكة وغطى رأسه بسترته القذرة وفعل ما فعل، تجاهل الجميع المنظر المنفر وتجاهلته معهم وحمدت الله أني وصلت محطتي في سلام.
هذه النماذج المرضية ليست قاصرة إذن على مجتمعنا، بل يمكن لمثل هذه الظواهر أن تحدث في أرقى الدول والحضارات.
ولكن ألا ترون معي أن هناك فرقا جوهريا بين هذا الأمر المؤسف وقصة الشاب الذي درس الطب لسنوات طويلة واجتهد حتى عُيّن معيدًا بإحدى كلياته؟
في الحالة الأولى نحن بصدد “حطام إنسان” قضى عليه اليأس، ولعله مدمن للكحول أو المخدرات أو ما شابه، ونادرا ما ستجده حاصلا على أي قسط من التعليم، فمن شبه المستحيل أن يقدم شخص لديه ولو بصيص امل في الحياة على فعل كهذا سوف يكلفه غاليا.
أما طبيبنا الشاب فلا ينتمي إلى تلك الشريحة على الإطلاق، بل برغم ما حصل عليه من علم وعلام كان يفترض بهما أن يرتقيا به ماديا وإنسانيا، فإذا به يظل حبيسا لظروفه المادية والاجتماعية والثقافية التي منعته، ليس من الزواج فحسب ولكن من ادراك الوسيلة السوية للتعامل مع الجنس الآخر، فصار عقله مضببًا مشتتًا طائحًا في كل اتجاه كالثور الهائج تكاد تعصف به هرموناته المتفجرة. يسمع عن العلاقات ولا يعرف كيف يدخلها، يسمع عن الجنس ولا يفهم كيف يمارسه، يعرف بشدة أنّ لديه رغبات ولا يعرف كيف يروضها ويهذبها.
بصراحة لا أرى عجبا أن استفحلت الرغبة المكبوتة لسنين داخل هذا البائس الذي ربما لا توجد في محيطه أية فتيات والذي ربما لم يتبادل حوارًا منفردًا مع فتاة في حياته لسبب اأو لآخر من إسبابنا العجيبة، فوقع على شابة بريئة في المواصلات العامة وقرر أن يتعرى أمامها، ليس مما يستر عورته الجسدية فحسب ولكنه شلح أمامها كذلك عورته النفسية عامدا متعمدا في حالة أشبه بنوبة الهستيريا الجنونية، مضحيا بذلك للأسف بسمعته ومستقبله وكل ما اجتهد من أجله.
فهل ما فعله خطأ فادحا وجريمة يعاقب عليها القانون؟ نعم بكل تأكيد.. ولكن لدينا طريقتان للنظر إليه والتعامل معه.
فإما أن ندين هذا الطبيب الشاب ونلعنه ونلقي بالتهمة على والديه اللذين لم يُحسنا تربيته أو على ضعف الوازع الديني لديه أو أي شيء آخر يبتعد بنا عن الحقيقة فنكتفي بمعاقبته كحالة فردية شاذه لا كعرض على مرض.
وإما أن نستثمر وقتا في دراسة ما يمكن أن يدفع بطبيب شاب يفترض فيه أن يكون “حكيما”، وهو بالمناسبة الاسم القديم للطبيب والذي ما زال مستعملا ببلاد الشام، كما وما زالت نقابة الأطباء بمصر تتمتع بلقب “دار الحكمة”، كيف وصل خريج كلية الطب ومعيدها وأستاذ وربما رئيس قسم أو جامعة المستقبل إلى هذا الحال المشين له ولأهله ولمجتمعه؟ وهل سلوكه المشين هذا حقا سلوك فردي شاذ أم أن أحداثا لا تقل في شذوذها عن تلك أصبحت تحدث بشكل عَفوي وتلقائي تماما في مجتمعنا وسط تجاهل ومباركة الجميع؟
هل يتحمل هذا الطبيب وحده وزر فعلته هذه أم يتحمل المجتمع معه المسئولية؟
الحقيقة التي لا نريد أن نراها، فضلا عن أن نعترف بها، هي أن مجتمعنا المريض أصبح مصنعا لشتى العاهات النفسية، الحقيقة أننا ضائعون تائهون مشتتون بين عشرات الأفكار والولاءات التي ليس من بينها تلك الولاءات الوحيدة التي نحتاجها حقا وهي الولاء للعقل والأرض، العقل الذي يهدي ويميز بين الصواب والخطأ وبين الحقيقة والخرافة وبين الواقع والخيال وبين الأخلاق والوضاعة، والأرض التي تطعم وتسقي وتجمع وتحمي والتي بدونها لا نكون.
وبسبب ضعف ولاءنا للعقل تحديدًا، وإصرارنا على تقزيمه وتعطيله عن العمل أصبح أحكم من فينا جاهلا!